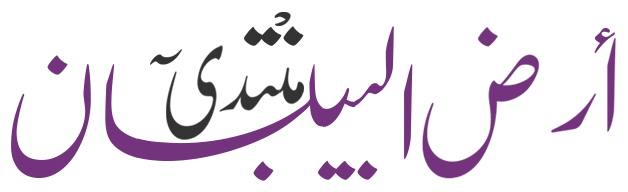DE$!GNER

بيلساني محترف




- إنضم
- Apr 4, 2011
- المشاركات
- 2,637
- مستوى التفاعل
- 44
- المطرح
- بين الأقلام والألوان ولوحات التصميم


هل المقالة فن سهل وصعب أفقياً وعمودياً كما ذهب إلى ذلك الدكتور خليل الموسى في كتابه الصادر هذا العام عن الهيئة العامة للكتاب أم أننا ملزمون بالعودة إلى المعنى اللغوي أي فن القول، وهو الكلام على الترتيب تاماً كان أو ناقصاً وهو الرأي والاعتقاد في لسان العرب وهي في المعاجم العربية المعاصرة: قطعة من الكتاب أو بحث ينشر في جريدة أو مجلة ومنه المقالة السياسية والمقالة العلمية وهي في المعاجم الفرنسية كما ينقل عنها الدكتور الموسى: كتاب أو بحث يقدم بصراحة تامة أفكاراً من دون ادعاء كامل.
لكنه يرى ذلك أن الخوض في تعريف فن المقالة لا يفضي إلى نتيجة، فهي ذات تعريفات عدة وخاصة لدى كتابها، فكل منهم يعرفها حسب كتابته، ثم هي كثيرة الأنواع والموضوعات والطرائق فضلاً عن طولها في كتاب وقصرها في الصحيفة، فزكي نجيب محمود يعرف المقالة حسب جونسون فيقول: إنها نزوة عقلية لا ينبغي أن يكون لها ضابط من نظام، هي قطعة لا تجري على نسق معلوم، ولم يتم هضمها في نفس كاتبها، وليس الانشاء المنظم من المقالة الأدبية في شيء، ويعرفها سيد قطب باختصار شديد «المقالة فكرة قبل كل شيء غايتها الاقناع الفكري».
ويذكر الباحث أن المقالة في أوان نشأتها لم يتوافر لها المناخ الملائم من حرية القول فالممنوعات توافدت عليها من العادات والتقاليد الاجتماعية من جهة ومن الأنظمة العربية الصارمة من جهة أخرى وقد كانت الصحافة العربية محاصرة منذ نشأتها فإما أن تكون في خدمة السلطان وإما أن تغلق أبوابها ويستذكر ما جرى مع خليل مطران صاحب «المجلة المصرية» حين سلط قانون المطبوعات على الأفكار واضطهاد والصحافة الحرة فقال ساخراً.
شردوا أخيارها بحراً وبراً واقتلوا أحرارها حراً فحراً
إنما الصالح يبقى صالحاً آخر الدهر ويبقى الشر شراً
كسروا الأقلام هل تكسيرها يمنع الأيدي أن تنقش صخراً
قطعوا الأيدي هل تقطيعها
يمنع الأعين أن تنظر شزراً
أطفئوا الأعين هل اطفاؤها يمنع الأنفاس أن تصعد زفرا
أخمدوا الأنفاس هذا جهدكم وبه منجاتنا منكم فشكراً
ولما انتشرت هذه الأبيات بين الناس ووصلت إلى رياض باشا رئيس الوزراء حينذاك توعد الشاعر بالنفي من مصر.
وللمقالة ثلاثة أنواع: مقالة ذاتية ومقالة موضوعية ومقالة صحفية.
أما الذاتية يطلق عليها أيضاً المقالة الأدبية تمييزاً لها من المقالة الموضوعية لطبيعتها الأسلوبية المجازية فهي تقترب كثيراً من شعرية السرد وتصل أحياناً إلى درجة عالية فيها.
والمقالة الموضوعية هي التي تعاد في أصولها إلى الكاتب الانكليزي فرنسيس باكون المتأثر بمحاولات مونتين ولكنه سار في أسلوبه في اتجاه مختلف فلم يسترسل في كتاباته ولم يستبطن أعماق نفسه أو يعبر عن تجاربه وإنما ذهب إلى تصميم مقالاته وتركيز أفكارها وتنسيقها واهتم بالموضوعات فأبدع بدوره المقالة الموضوعية بالتطور الذي أحدثه.
والمقالة الصحفية: هي عبارة عن زاوية صحفية أو خاطرة أو فكرة يخصص لها مكان ما في صحيفة يومية وهي أيضاً ليست واحدة ولكنها تقوم في معظمها على فكرة محددة يطرحها الكاتب في مطلعها ثم يأتي بالشواهد عليها ليصل بعد ذلك إلى خلاصة أو نتيجة ويحصر أحد دارسيها ألوانها في المقالة الافتتاحية وهي تتناول الموضوع الرئيس في الصحيفة.
الاختلافات الأسلوبية والأسلوب هو الرجل كما يقول جورج بيغون ولكي يكون للكاتب أسلوب فهذا يعني أن له علامة فارقة وهي تختلف عن سواها من العلامات وإذا كان الأسلوب يتجلى في الشعر غالباً أكثر مما يتجلى في النثر فإن ذلك لا يعني عدم تجلياته في النثر الفني الذي يتوسط فيما بين الشعر والنثر العلمي وقد اختار المؤلف المنهج التاريخي فيما اتبع من بحث عن المقالة في سورية تطورها وأعلامها في القرن العشرين حتى اليوم فهو الأصلح والأنسب من وجهة نظره.
وبهذا الكتاب يكون الدكتور الموسى قد سدّ فراغاً كبيراً في هذا المجال إذ تخلو المكتبة العربية من دراسات حول فن المقالة في سورية باستثناء محاولة وحيدة بعنوان فن المقالة في سورية بين 1946- 1980 لمها فائق العطار.
ويؤكد الباحث أن المقالة تحتاج إلى دراسات أسلوبية وسيميولوجية وبنيوية كما تحتاج إلى دراسات متخصصة في موضوعاتها وأنواعها وأشكالها.
__سيميولوجية: «نوع من الدراسات المعاصرة جداً وهي الاشارات ذات الدلالة».